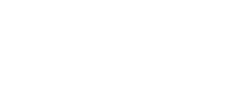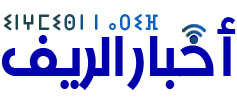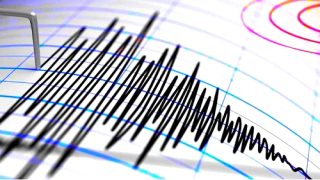يبدو أن المقال المعنون بـ “أين المثقف الريفي؟” للكاتب محمد امزيان يحاول أن يقدم إجابة متوازنة على سؤال يتكرر في النقاشات العامة سواء داخل الريف أو خارجه، لكنه في العمق يعيد إنتاج نفس الإشكال الذي يدعي تجاوزه. الكاتب يبدأ من موقف يشكك في وجود المثقف الريفي أصلا، ثم ينتهي إلى القول إنه موجود لكنه مظلوم أو مجهول، وهذا تحول غير مبرر من الناحية المنهجية، لأن المعيار الذي اعتمده في تعريف “المثقف” ظل غامضا ومتحركا. فمرة يربطه بالإنتاج الفكري، ومرة بالموقف من السلطة، ومرة أخرى بمجرد الوعي بالذات والمجتمع، مما يجعل أحكامه نسبية ومتناقضة.
الكاتب يحمل المجتمع الريفي مسؤولية ضعف الفعل الثقافي، حين يقول إن هذا المجتمع لا يحتاج إلى “زاد ثقافي بعيد المدى”، بل إلى “ثقافة السندوتش”، وهي عبارة تنطوي على نظرة استعلائية تفرغ النقاش من عمقه الاجتماعي. فإذا كان المجتمع لا يقبل الثقافة، والمثقف غير مسؤول عن هذا الرفض، فمن يتحمل إذن مسؤولية هذا الفراغ؟ الكاتب يبرئ المثقف، ويلوم الناس، متناسيا أن وظيفة المثقف ليست في انتظار مجتمع مثالي، بل في العمل داخل واقع ناقص لتغييره. المثقف الحقيقي لا يقف في موقع المراقب، بل في موقع الفاعل الذي يخلق الوعي النقدي ويؤثر في الحس الجماعي.
وإذا استحضرنا تصور أنطونيو غرامشي للمثقف، سنجد أن المثقف ليس كائنا معزولا، بل هو فاعل اجتماعي منخرط في صراعات الحياة اليومية، يسعى إلى بناء “هيمنة ثقافية” بديلة عن تلك التي تفرضها الطبقة المسيطرة. المثقف عند غرامشي ليس ذلك الذي ينعزل في برجه العاجي، بل هو الذي ينحاز إلى قضايا الناس، ويعمل على تحويل الوعي الشعبي إلى قوة تاريخية. بهذا المعنى، فالمثقف الريفي ليس مجرد ناقد للسلطة، بل هو جزء من حركة تحرر رمزية تسعى إلى تفكيك المركزية الثقافية والسياسية التي تجعل من الهامش مجرد تابع.
أما إدوارد سعيد، فيرى أن المثقف هو “الهاوي” الذي يقف في وجه السلطة والنظام القائم، ويقول الحقيقة في وجه القوة، دون أن يتحول إلى موظف أو بوق أيديولوجي. هذا المفهوم يضع المثقف في موقع أخلاقي، لا يقاس بما يملكه من شهرة أو إنتاج، بل بقدرته على أن يكون “ضميرا ناقدا” لمجتمعه وسلطاته. وإذا ما طبقنا هذا التصور على الحالة الريفية، ندرك أن المثقف الريفي لا يغيب، بل يقصى لأن خطابه لا يخدم منطق المركز، ولأنه يفضح تناقضات السلطة وخطاباتها عن التنمية والعدالة.
من زاوية سوسيولوجية، يمكن القول إن غياب المثقف الريفي ليس مسألة وجود فرد أو عدمه، بل نتيجة بنية اجتماعية هرمية تعيد إنتاج التفاوت الرمزي والمادي بين المركز والهامش. فالمجتمع المغربي، مثل كثير من المجتمعات ما بعد الكولونيالية، يقوم على مركز ثقافي يتمثل في المدن الكبرى (الرباط، الدار البيضاء، فاس) حيث تتجمع المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومراكز القرار الثقافي، في مقابل هامش جغرافي وثقافي يتمثل في المناطق الريفية، حيث شح وندرة الاستثمار في البنية الثقافية والتعليمية. هذا التفاوت البنيوي يجعل المثقف الريفي يفتقر إلى الوسائل والفضاءات التي تحول إنتاجه إلى حضور، فيبقى محاصرا داخل مجاله المحلي.
كما أن المقاربة السوسيولوجية تكشف أن رأس المال الثقافي، بتعبير بيير بورديو، لا يتوزع بشكل متكافئ. فالمثقف الريفي، حتى حين يمتلك المعرفة والوعي، يفتقد رأس المال الرمزي الذي يمنحه الشرعية داخل الحقل الثقافي الوطني، لأن هذا الحقل تهيمن عليه معايير المركز: اللغة، الانتماء الطبقي، وسلطة المؤسسات الرسمية. إن غياب المثقف الريفي عن المشهد ليس إذن دليلا على ضعفه الفكري، بل على ضعف موقعه في البنية الاجتماعية التي لا تسمح لصوته أن يتحول إلى خطاب مسموع.
أما من منظور أنثروبولوجي، فإن صورة المثقف الريفي ترتبط ايضا بتمثلات الثقافة المحلية وموقعها في النسق القيمي والاجتماعي. فالثقافة في السياق الريفي ليست مفهوما مؤسساتيا أو نخبوياً، بل هي ممارسة حياتية متجذرة في اللغة والعرف والرمز والذاكرة الجماعية. إن النظرة الأنثروبولوجية تكشف أن المثقف الريفي قد لا يتجلى في شكل الكاتب أو المفكر التقليدي، بل في الامغار الحكيم أو الراوي أو الفاعل الجمعوي الذي يحافظ على التوازن الرمزي للمجتمع. هذا المثقف ليس بالضرورة حاملاً لشهادة أو منتجا لنصوص، بل هو حامل لوعي ثقافي محلي يعيد إنتاج القيم الجماعية ويمنحها شرعية في مواجهة العولمة الثقافية وهيمنة خطاب المدينة.
المقاربة الأنثروبولوجية تظهر أيضا أن العلاقة بين “الثقافة”و”المثقف” في الريف محكومة بمنظومة القرابة والانتماء الجماعي داخل القبيلة نفسها او خارجه. فالمثقف هنا ليس فردا مستقلا عن الجماعة/ القبيلة، بل جزء منها، يمارس نقده من داخلها لا من فوقها. لذلك، فإن صمته أحيانا لا يعني تواطؤا، بل حرصاً على الحفاظ على توازنات اجتماعية دقيقة، حيث الكلمة يمكن أن تقرأ بوصفها تحديا للعرف أو تهديدا للانسجام الاجتماعي. هذه الحساسية تجاه البنية الجماعية تجعل الفعل الثقافي في الريف مشروطا بالانتماء أكثر منه بالتحرر الفردي، وهو ما لا يلتقطه الكاتب حين يتحدث عن المثقف ككائن معزول أو “نبي مجهول”.
وإذا ما أضفنا المقاربة التاريخية الواقعية، التي تنظر إلى المثقف بوصفه نتاجا لتطور تاريخي مرتبط بالبنية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نجد أن المثقف الريفي هو امتداد لمسار المقاومة الرمزية والمادية التي عرفها الريف عبر تاريخه، من ثورات التحرر إلى الحركات الثقافية الحديثة. المدرسة التاريخية الواقعية، كما تتجلى في الفكر الماركسي وما تفرع عنه من تحليلات نقدية، ترى أن المثقف ليس فوق التاريخ، بل هو ابن لظروفه المادية، ونتاج لعلاقات الإنتاج وموازين القوى. من هذا المنظور، لا يمكن الحديث عن “غياب المثقف الريفي” إلا بقدر ما نفهم شروط إنتاجه التاريخية، التي تظل محدودة بفعل سياسات التهميش والاقتصاد الريعي وهيمنة المدينة كمركز للسلطة ورأس المال.
المثقف، في التصور التاريخي الواقعي، ليس مفكرا حراً بالمعنى الرومانسي، بل هو فاعل تاريخي مرتبط بمرحلة معينة من تطور المجتمع. وحين نسقط هذا على الواقع المغربي، يتبين أن المثقف الريفي لم يهمش لأن المجتمع الريفي عاجز عن إنتاج مثقفيه، بل لأن الدولة الحديثة — منذ الاستقلال — أعادت إنتاج نفس البنية المركزية التي تقصي الهامش اقتصاديا وثقافيا، وتحول دون تشكل طبقة مثقفة محلية مستقلة. هذا ما يجعل المثقف الريفي، في كثير من الحالات، محكوماً بالاغتراب المزدوج: اغتراب عن مركز القرار، واغتراب عن مجتمعه الذي ينظر إليه من خلال عدسة السلطة.
المقال الذي نناقشه يسقط في خلط بين المثقف والسياسي. فحين يقول الكاتب إن المثقف ليس فاعلا سياسيا، وأن مهمته “تقويم المعوج ثقافياً وديمقراطياً”، فهو في الحقيقة يؤكد البعد السياسي للمثقف من حيث لا يدري، لأن تقويم الديمقراطية فعل سياسي بامتياز. لا يمكن للمثقف أن يكون لا سياسيا وهو يمارس النقد الاجتماعي والسلطوي في آن واحد. هذه المحاولة لفصل الثقافة عن السياسة تبدو هروبا من مسؤولية المواجهة، وتحويلا للمثقف إلى كائن محايد بلا موقف.
وحين يشبه الكاتب المثقف الريفي بـ “النبي المجهول” الذي يبلغ رسالته في صحراء قاحلة، فإنه يستبدل النقد الواقعي بالرمز الطوباوي، ويعيد إنتاج فكرة “البرج العاجي” التي انتقدها قبل ذلك بأسطر قليلة. في لحظة واحدة يتحول المثقف من إنسان عادي يحمل هموم الناس إلى نبي يعيش في عزلة، مما يعكس ارتباكا في تصور دوره ومكانته داخل المجتمع.
كما أن السؤال الذي طرحه الكاتب: “لماذا أبعد المثقف الريفي عن الساحة؟” ظل دون إجابة حقيقية. فالإبعاد لا يمكن فهمه خارج سياقه البنيوي المرتبط بمركزية السلطة والثقافة في المغرب، وبسياسات التهميش اللغوي والثقافي للمناطق الأمازيغية بشكل عام، وبغياب بنى تحتية ثقافية مستقلة في الريف بشكل خاص. لكن المقال يختزل هذا كله في فكرة نفسية أو ذوقية مفادها أن الناس لا يريدون الثقافة، وهي قراءة سطحية تتجاهل الأسباب المادية والسياسية العميقة.
إلى جانب ذلك، يميز الكاتب بين “المتعلمين” و”المثقفين”، ويعتبر أن الريف لا يملك سوى فئة من المتعلمين الذين يعيدون تدوير الأفكار، لا إنتاجها. غير أن هذا الفهم للنشاط الثقافي يختزل الثقافة في الكتابة والتنظير، ويغفل أشكال الإنتاج الرمزي الأخرى: المسرح، الموسيقى، الفعل الجمعوي، الحراك المدني، وهي كلها مجالات يتجلى فيها المثقف الحقيقي، لا في صفة الكاتب أو الفيلسوف فقط. فالإنتاج الفكري ليس مجرد نصوص، بل مواقف وممارسات.
وفي خاتمته، يطرح الكاتب سؤالا بلاغيا: “هل عدم معرفتنا بالشيء معناه عدم وجوده؟” لكنه بذلك يعيد إنتاج نفس الذاتية التي حكم بها في البداية، إذ جعل تجربته الشخصية معيارا لوجود المثقف أو غيابه. فالمسألة لا تتعلق بمعرفة فردية، بل ببنية اجتماعية وثقافية وتاريخية تحدد من يرى ومن يحجب، ومن يُمنح المنبر ومن يُقصى منه. المثقف الريفي ليس غائبا، بل مغيب بفعل منظومة تهميش تمتد من الإعلام إلى المؤسسات التعليمية والثقافية، ومن البنى الاجتماعية إلى التمثلات الرمزية، ومن التاريخ الرسمي إلى الذاكرة المنسية.
إن المقال الذي حاول البحث عن “المثقف الريفي” سقط في فخ التعميم والتبسيط، لأنه لم ينطلق من مرجعية فكرية واضحة أو مدرسة نظرية وازنة يمكن أن تمنحه عمقا تحليليا متماسكا. فقد افتقر إلى إطار مفاهيمي يستند إلى الفلسفة أو علم الاجتماع أو التاريخ، واعتمد بدلا من ذلك على ملاحظات انطباعية وتجارب ذاتية تعيد إنتاج رؤية جزئية وغير مؤسسة. غابت عنه المقاربة الجدلية التي تربط المثقف بشروطه التاريخية والاجتماعية، كما غابت الرؤية النقدية التي تجعل من الثقافة فعلا تحرريا لا وصفا سطحيا للواقع. لذلك، فإن المقال، رغم حسن نيته في إثارة السؤال، ظل يدور في دائرة الذات والتقدير الأخلاقي، دون أن يبلور فهما معرفيا دقيقا لوظيفة المثقف في الريف ولا لآليات تهميشه داخل النسق العام للمجتمع.
فريد آيث لحسن
لاهاي- هولندا
خريف 2025